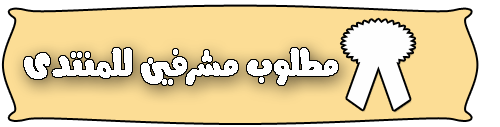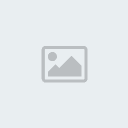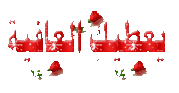لحظة وفاءصقر ماسي
لحظة وفاءصقر ماسي
- عدد المشاركات : 1640
العمر : 42
أوسمة التميز :
تاريخ التسجيل : 10/01/2009
 حرب غزة.. الدين والسياسة والإنسان .....
حرب غزة.. الدين والسياسة والإنسان .....
الخميس فبراير 12, 2009 2:42 pm
حرب غزة.. الدين والسياسة والإنسان .....
أصبحنا نرى كيف تتفجر ينابيع الخرافة في مثل هذه الأحداث التي يختلط فيها التدين التقليدي بوقائع قومية ملتهبة، وقائع نارية تحرق مشاعر البسطاء؛ فلا يستطيعون تمييز الحدود الفاصلة بين العقل والخرافة من جهة، ولا الحدود الفاصلة بين الدين والخرافة من جهة أخرى. وبهذا تحضر الخرافة كفاعل رئيس في الرؤية في الفعل. ومن ثم تنتقل؛ لتكون - إضافة إلى ما سبق - جزءا من مكونات الخطاب السياسي المتدين. أي أنها تتجاوز اللحظة بشروطها الراهنة؛ لتكون فاعلة في سياق أعم واشمل. عندما تتفجر ينابيع الخرافة في مثل هذا السياق السياسي، وهو السياق الذي يحتاج أشد ما يحتاج إلى معاينة الواقع كما هو، فإن المواجهة مع العدو تصبح وكأنها مواجهة بين الوقائع المحسوبة بأعلى درجات العقل والتعقل والعلم؛ من جهة العدو، وبين ترسانة من الأوهام والخرافات؛ من جهتنا. والمواجهة على هذا النحو هي معركة انتحار، لا انتصار؛ معركة عبثية، تصنع المآسي والكوارث؛ لا الانتصارات. فالجيوش المدعّمة بأحدث مخرجات العلم الحديث، يستحيل أن تواجه بأوهى خرافات الماضي، ولو على سبيل المجاز، أو الكذب المباح!. 2-14- ما فعلته وتفعله حماس، هو مؤشر على ما يمكن أن تفعله الحركات المتطرفة؛ فيما لو وصلت إلى الحكم في أي دولة عربية أو إسلامية. فالديمقراطية - حتى في صورها الجزئية الأولى - ليست من مكونات الوعي الإسلاموي المعاصر؛ لأن البنية الثقافية التي تحكم - في العمق - هذا الوعي، هي على حال من التضاد التام مع كل قيم الحرية وأشكالها، تلك القيم التي تُعدّ الممارسة الديمقراطية أحد تجلياتها العامة. وكل التأكيدات التي يتبرع بها الحراك الإسلاموي في هذا السياق، هي مجرد حرب شعارات من جهة، وتوطئة للوصول إلى مراكز صنع القرار من جهة أخرى. صحيح أن هناك إشكالية في التعامل مع مفردات الديمقراطية في مجمل الثقافة العربية. لكن، يبقى الخطاب الإسلاموي - دون غيره - يمتلك منظومة متكاملة من القيم المشرعنة التي تضاد الحريات. وهي قيم يجري تأسيسها على قاعدة عقائدية مدموغة بطابع الثبات والتأبيد الأزلي. وهذا يعني أن الإسلاموي لا يمكن أن يتسامح مع الديمقراطية إلا بالتنازل عن إسلامويته (عن إسلامويته، وليس عن إسلامه) أي عن المرتكزات الأساسية في خطابه السياسي. بينما العربي، أو المسلم غير الإسلاموي، لا يحتاج إلا إلى خطوات طويلة الأمد، للتربية - ثقافيا وعمليا - على الممارسة الديمقراطية؛ لأنه - على الأقل، وعكس الإيديولوجي الإسلاموي - لا يمتلك تشريعا عقائديا مضادا للحريات. كل هذا يؤكد أن الحركات الإسلاموية لا تؤمن - ولا يمكن أن تؤمن - بالممارسة الديمقراطية؛ مهما كانت التطمينات والتأكيدات. بل إنها لو أرادات - صادقة - أن تكون ديمقراطية، فهي لا تستطيع ذلك؛ لأن هناك ما هو أقوى من إرادتها الظرفية الراهنة. وهذا يعني أن دخول هذه الحركات في الممارسات الديمقراطية، هو مجرد خطوات انقلابية، تتغيا الوصول إلى الانقلاب الخطير والحاسم، الذي من خلاله تبدأ رحلة الانهيار والدمار للجميع. لقد أشرت من قبل، وبمجرد فوز حماس في الانتخابات، إلى مأزق حماس، وإلى الكارثة المنتظرة. فحماس حركة إسلاموية متطرفة. وهذه حقيقة يعرفها الجميع. وقراءات أدبيات حماس، وطبيعة تكوينها وانتماءاتها، تؤكد حقيقة تطرفها الشديد. الجميع يعرف ذلك. لكن؛ لأن حماس في أرض محتلة، وتقوم بدور من أدوار المقاومة، فقد جرى التغاضي عن تطرفها من قبل كثير من مفكري العرب والمسلمين. يدلك على هذا، أن حماس لو كانت في بلد عربي أو إسلامي؛ لتم تصنيفها كإحدى حركات التطرف الإرهابي، ولتمت محاكمتها على كل جريمة عنف ترتكبها باسم الإسلام. هذا يعني أن الوثبة الحمساوية على السلطة، كانت غلطة الجميع. كانت غلطة الحمساويين طبعا، ولكنها - قبل ذلك وبعده - هي غلطة أولئك الذين سمحوا بنجاح هذا الاحتلال الحمساوي للسلطة، ومن قبل للشارع. وفي اعتقادي، لا ينبغي التفريق بين وجود الحركات المتطرفة في وطن حر مستقل، ووجودها في وطن محتل. فالتطرف الإرهابي هو بنية ثقافة كامنة في الوعي، قبل أن يكون نمط سلوك متعينا في الواقع. والإرهابي الذي يمارس الإرهاب بثقافة الإرهابي في هذا المكان، سيمارسه - حتما - في كل مكان، ولو في أقدس مكان، بين الحجر والمقام.
لا تنحصر مأساة وصول الحركات المتطرفة إلى مواطن اتخاذ القرار، بما سوف تمارسه من مصادرة للحريات العامة والخاصة، ولا بما سيجري علي يديها من التنكيل بكل المخالفين لها، ولو بأدنى درجات المخالفة، ولا بأنها ستحتكر الحق والحقيقة، ولا بأنها ستقوم بتحطيم كل مشاريع التنمية، ولو كانت مشاريع كسيحة تزحف على بطونها، وإنما هي - فوق كل هذا - ستقوم بالتحكم بالقرارات المصيرية للأمة، وسيتم ذلك التحكم بوعي ربع عاقل أو بوعي ثلاثة أرباع مجنون. عندما يكون (وطن) ما، (طائرة) مختطفة من قبل إرهابيين، فإن المأساة لا تتوقف عند حدود ترويع الركاب وإذلالهم، ولا حتى عند قتل بعضهم؛ كما يتصور بعض المتفائلين، وإنما ستكون المأساة الحقيقية هي وصول هؤلاء الإرهابيين المغامرين إلى (قمرة القيادة) والجلوس على مقعد التحكم بالمصير النهائي للجميع. لن تكون المسألة مجرد مغامرة بهلوانية، بل ولا مجرد تحليق إلى المجهول، وإنما ستكون المغامرة تحليقا إلى الهاوية، إلى قاع النهاية، ستكون انتحارا عدميا. ما وقع من انقلاب على يد حماس، وما وقع من قَبْل على يد الحزب الإيراني في لبنان، وما كان على وشك الوقوع بداية التسعينيات من القرن الماضي في الجزائر، كلها مؤشرات من صلب الواقع على ما يمكن أن يقع في كل بلد تتوسل فيه الحركات المتطرفة مجالات الفعل الديمقراطي. ما فعلته حماس بتديين الصراع، وما قادها إليه هذا التديين من التزامات ولوازم حركية وفكرية، ستفعله - حتما - الحركة الأم (= الإخوان) التي تنتمي إليها حماس؛ فيما لو تمكنت من الاستيلاء على السلطة؛ عبر وسائل العمل الديمقراطي. فالديمقراطية - عند هذه الحركات - مجرد قنطرة إلى الاستبداد، بل وإلى جنون (= مغامرات) الاستبداد أيضا.
3- سؤال الشرعية. ويتفرع منه: شرعية قيادة الحرب!. وهذا هو سؤال الأسئلة، الذي لا زال مطروحا - بقوة السياق - ولا زالت حماس تهرب منه مذعورة في كل الاتجاهات، ومنها جبهة الصراع. كل الإشكاليات التي رافقت وترافق الواقع المأساوي في غزة خاصة، وفي فلسطين عامة، إشكاليات ستبقى معلقة؛ ما لم يكن هذا السؤال محسوما على مستوى الإدارة، وعلى مستوى الرأي العام.
واضح أن سؤال الشرعية هذا، هو السؤال المقلق، بل والمستفز لحماس. ولهذا فهي مستعدة للتعاطي مع كل أحد!؛ شرط أن يسكت عن طرح هذا السؤال المحرج لها، والذي تحاول الحركة طمره ولو بأشلاء القتلى من أبناء الشعب الفلسطيني، ذلك الشعب الذي تنتمي إليه دما، ولكنها تفارقه، بل وتضاده، حركة وتنظيما وانتماء. ولهذا، فهي تحاول استجداء هذه الشرعية المفقودة من الداعم الإيراني، من الداعم الذي تحاول حماس - بأمواله الطاهرة! - شراء التأييد لها في الداخل الفلسطيني، على طريقة الشاعر الذي يقول: نأسو بأموالنا آثار أيدينا.
إذن، انعدام الشرعية لم يبدأ - وإن تأكد - بإقالة حكومة حماس. فدخولها في العملية الديمقراطية لم يكن شرعيا من الأساس؛ لأنها - كما ينصُّ ميثاقها وانتماؤها الحركي - لا تؤمن بشرعية النظام / السلطة التي تحاول الفوز بها، وليس لديها الاستعداد - الاستعداد الحقيقي - لممارسة السلطة بشروط السلطة؛ لأنها - كما تقول وتؤكد دائما - حركة مقاومة مسلحة. وهي تعد الكفاح المسلح هو القاعدة الشرعية لها. وهذه القاعدة الشرعية هي (فعل) خارج نطاق السلطة، أو يجب أن يبقى خارج نطاقها. فشرعية حماس - إن وجدت ولو بكثير من التجاوز - شرعية توجد - بالضرورة - خارج السلطة، لا داخلها.
على هذا، فحين تأتي حماس إلى السلطة، فإنه يجب عليها التنازل عن شرعيتها، شرعية وجودها، أو التنازل عن السلطة. وهذا ما يستحيل فعله واقعا. ولكن حماس وهي تتهالك على فتات السلطة تحاول فعل المستحيل. وحين ترتطم بجدار المستحيل الصلب؛ فإنها لا تتراجع، بل ولا حتى تمارس الخيار بين هذا وذاك، وإنما تلوم المستحيل لأنه مستحيل، وتعادي كل من يؤكد لها استحالة هذا المستحيل. ولا شك أن عقلا مأزوما كهذا، يستحيل عليه أن يتقدم خطوة واحدة في عالم السياسة؛ لأن السياسة تبدأ من نقطة الشرعيات المكتسبة، والمعترف بها من قبل المؤثرين - حقيقة - في السياق، وتمر عبر جسور الممكن والآني، ولا تنتهي إلا حيث تنتهي الإرادات الإنسانية الفاعلة. لقد واجهت حماس من بداية التسعينيات منذ القرن الماضي، وإلى اليوم، كثيرا من المآزق والأزمات، بل والتحديات من الداخل والخارج. لكن، ما يلفت النظر أن كل مأزق وكل أزمة، إنما كانت مرتبطة - على نحو لافت - بسؤال الشرعية. وفي كل مرة، كانت حماس تتوسل الشرعية - صراحة - إلى درجة الاستجداء، ولكنها - في الوقت نفسه - تهرب من شروطها الفكرية والعملية. كل المآزق الحمساوية، كانت ستكون قابلة للحل؛ فيما لو كان سؤال الشرعية محلولا، أو كانت شروطه قابلة للتفاوض.
لا يمكن فهم هذا السؤال الحاسم في سياق القضية، إلا بمراجعة الخطوط العريضة - دون الدخول في التفاصيل؛ مع أهميتها - لمسيرة علاقة حماس بالسلطة من جهة، وعلاقتها بالواقع الفلسطيني من جهة أخرى. فعندما بدأ تأسيس السلطة الوطنية بداية التسعينيات على مبدأ: خيار السلام، كتمهيد لتأسيس الدولة الفلسطينية الجامعة، كان رد حماس على هذا الخيار الفلسطيني، قيامها بتفجيرات إرهابية كبيرة عام 1994م في العمق الإسرائيلي؛ بغية إيقاف عملية السلام. كانت خطة حماس تمثل مشروعا ضد السياق المدني آنذاك. وهي خطة لا تكمن في مجرد إفساد السياق السلمي فحسب، وإنما تحاول - أيضا - الحصول على شرعية شعبية، من خلال العنف الدموي؛ كمقابل موضوعي للشرعية التي كان عرفات يحصل عليها من خلال عملية السلام. كانت حماس - آنذاك - تريد اعترافا - ولو هزيلا - من قبل الداخل الفلسطيني على الأقل. وكانت ترى في التفجيرات الإرهابية طريقا إلى عقل جماهيري مأزوم ومتخم بشعارات القوة الكاذبة، ووقائع النضال التاريخي!. وقد حقق لها هذا العبث المراهق نوعا من الشرعية، ولكنها كانت شرعية (شوارعية) على حساب مستقبل القضية الفلسطينية برمتها
أصبحنا نرى كيف تتفجر ينابيع الخرافة في مثل هذه الأحداث التي يختلط فيها التدين التقليدي بوقائع قومية ملتهبة، وقائع نارية تحرق مشاعر البسطاء؛ فلا يستطيعون تمييز الحدود الفاصلة بين العقل والخرافة من جهة، ولا الحدود الفاصلة بين الدين والخرافة من جهة أخرى. وبهذا تحضر الخرافة كفاعل رئيس في الرؤية في الفعل. ومن ثم تنتقل؛ لتكون - إضافة إلى ما سبق - جزءا من مكونات الخطاب السياسي المتدين. أي أنها تتجاوز اللحظة بشروطها الراهنة؛ لتكون فاعلة في سياق أعم واشمل. عندما تتفجر ينابيع الخرافة في مثل هذا السياق السياسي، وهو السياق الذي يحتاج أشد ما يحتاج إلى معاينة الواقع كما هو، فإن المواجهة مع العدو تصبح وكأنها مواجهة بين الوقائع المحسوبة بأعلى درجات العقل والتعقل والعلم؛ من جهة العدو، وبين ترسانة من الأوهام والخرافات؛ من جهتنا. والمواجهة على هذا النحو هي معركة انتحار، لا انتصار؛ معركة عبثية، تصنع المآسي والكوارث؛ لا الانتصارات. فالجيوش المدعّمة بأحدث مخرجات العلم الحديث، يستحيل أن تواجه بأوهى خرافات الماضي، ولو على سبيل المجاز، أو الكذب المباح!. 2-14- ما فعلته وتفعله حماس، هو مؤشر على ما يمكن أن تفعله الحركات المتطرفة؛ فيما لو وصلت إلى الحكم في أي دولة عربية أو إسلامية. فالديمقراطية - حتى في صورها الجزئية الأولى - ليست من مكونات الوعي الإسلاموي المعاصر؛ لأن البنية الثقافية التي تحكم - في العمق - هذا الوعي، هي على حال من التضاد التام مع كل قيم الحرية وأشكالها، تلك القيم التي تُعدّ الممارسة الديمقراطية أحد تجلياتها العامة. وكل التأكيدات التي يتبرع بها الحراك الإسلاموي في هذا السياق، هي مجرد حرب شعارات من جهة، وتوطئة للوصول إلى مراكز صنع القرار من جهة أخرى. صحيح أن هناك إشكالية في التعامل مع مفردات الديمقراطية في مجمل الثقافة العربية. لكن، يبقى الخطاب الإسلاموي - دون غيره - يمتلك منظومة متكاملة من القيم المشرعنة التي تضاد الحريات. وهي قيم يجري تأسيسها على قاعدة عقائدية مدموغة بطابع الثبات والتأبيد الأزلي. وهذا يعني أن الإسلاموي لا يمكن أن يتسامح مع الديمقراطية إلا بالتنازل عن إسلامويته (عن إسلامويته، وليس عن إسلامه) أي عن المرتكزات الأساسية في خطابه السياسي. بينما العربي، أو المسلم غير الإسلاموي، لا يحتاج إلا إلى خطوات طويلة الأمد، للتربية - ثقافيا وعمليا - على الممارسة الديمقراطية؛ لأنه - على الأقل، وعكس الإيديولوجي الإسلاموي - لا يمتلك تشريعا عقائديا مضادا للحريات. كل هذا يؤكد أن الحركات الإسلاموية لا تؤمن - ولا يمكن أن تؤمن - بالممارسة الديمقراطية؛ مهما كانت التطمينات والتأكيدات. بل إنها لو أرادات - صادقة - أن تكون ديمقراطية، فهي لا تستطيع ذلك؛ لأن هناك ما هو أقوى من إرادتها الظرفية الراهنة. وهذا يعني أن دخول هذه الحركات في الممارسات الديمقراطية، هو مجرد خطوات انقلابية، تتغيا الوصول إلى الانقلاب الخطير والحاسم، الذي من خلاله تبدأ رحلة الانهيار والدمار للجميع. لقد أشرت من قبل، وبمجرد فوز حماس في الانتخابات، إلى مأزق حماس، وإلى الكارثة المنتظرة. فحماس حركة إسلاموية متطرفة. وهذه حقيقة يعرفها الجميع. وقراءات أدبيات حماس، وطبيعة تكوينها وانتماءاتها، تؤكد حقيقة تطرفها الشديد. الجميع يعرف ذلك. لكن؛ لأن حماس في أرض محتلة، وتقوم بدور من أدوار المقاومة، فقد جرى التغاضي عن تطرفها من قبل كثير من مفكري العرب والمسلمين. يدلك على هذا، أن حماس لو كانت في بلد عربي أو إسلامي؛ لتم تصنيفها كإحدى حركات التطرف الإرهابي، ولتمت محاكمتها على كل جريمة عنف ترتكبها باسم الإسلام. هذا يعني أن الوثبة الحمساوية على السلطة، كانت غلطة الجميع. كانت غلطة الحمساويين طبعا، ولكنها - قبل ذلك وبعده - هي غلطة أولئك الذين سمحوا بنجاح هذا الاحتلال الحمساوي للسلطة، ومن قبل للشارع. وفي اعتقادي، لا ينبغي التفريق بين وجود الحركات المتطرفة في وطن حر مستقل، ووجودها في وطن محتل. فالتطرف الإرهابي هو بنية ثقافة كامنة في الوعي، قبل أن يكون نمط سلوك متعينا في الواقع. والإرهابي الذي يمارس الإرهاب بثقافة الإرهابي في هذا المكان، سيمارسه - حتما - في كل مكان، ولو في أقدس مكان، بين الحجر والمقام.
لا تنحصر مأساة وصول الحركات المتطرفة إلى مواطن اتخاذ القرار، بما سوف تمارسه من مصادرة للحريات العامة والخاصة، ولا بما سيجري علي يديها من التنكيل بكل المخالفين لها، ولو بأدنى درجات المخالفة، ولا بأنها ستحتكر الحق والحقيقة، ولا بأنها ستقوم بتحطيم كل مشاريع التنمية، ولو كانت مشاريع كسيحة تزحف على بطونها، وإنما هي - فوق كل هذا - ستقوم بالتحكم بالقرارات المصيرية للأمة، وسيتم ذلك التحكم بوعي ربع عاقل أو بوعي ثلاثة أرباع مجنون. عندما يكون (وطن) ما، (طائرة) مختطفة من قبل إرهابيين، فإن المأساة لا تتوقف عند حدود ترويع الركاب وإذلالهم، ولا حتى عند قتل بعضهم؛ كما يتصور بعض المتفائلين، وإنما ستكون المأساة الحقيقية هي وصول هؤلاء الإرهابيين المغامرين إلى (قمرة القيادة) والجلوس على مقعد التحكم بالمصير النهائي للجميع. لن تكون المسألة مجرد مغامرة بهلوانية، بل ولا مجرد تحليق إلى المجهول، وإنما ستكون المغامرة تحليقا إلى الهاوية، إلى قاع النهاية، ستكون انتحارا عدميا. ما وقع من انقلاب على يد حماس، وما وقع من قَبْل على يد الحزب الإيراني في لبنان، وما كان على وشك الوقوع بداية التسعينيات من القرن الماضي في الجزائر، كلها مؤشرات من صلب الواقع على ما يمكن أن يقع في كل بلد تتوسل فيه الحركات المتطرفة مجالات الفعل الديمقراطي. ما فعلته حماس بتديين الصراع، وما قادها إليه هذا التديين من التزامات ولوازم حركية وفكرية، ستفعله - حتما - الحركة الأم (= الإخوان) التي تنتمي إليها حماس؛ فيما لو تمكنت من الاستيلاء على السلطة؛ عبر وسائل العمل الديمقراطي. فالديمقراطية - عند هذه الحركات - مجرد قنطرة إلى الاستبداد، بل وإلى جنون (= مغامرات) الاستبداد أيضا.
3- سؤال الشرعية. ويتفرع منه: شرعية قيادة الحرب!. وهذا هو سؤال الأسئلة، الذي لا زال مطروحا - بقوة السياق - ولا زالت حماس تهرب منه مذعورة في كل الاتجاهات، ومنها جبهة الصراع. كل الإشكاليات التي رافقت وترافق الواقع المأساوي في غزة خاصة، وفي فلسطين عامة، إشكاليات ستبقى معلقة؛ ما لم يكن هذا السؤال محسوما على مستوى الإدارة، وعلى مستوى الرأي العام.
واضح أن سؤال الشرعية هذا، هو السؤال المقلق، بل والمستفز لحماس. ولهذا فهي مستعدة للتعاطي مع كل أحد!؛ شرط أن يسكت عن طرح هذا السؤال المحرج لها، والذي تحاول الحركة طمره ولو بأشلاء القتلى من أبناء الشعب الفلسطيني، ذلك الشعب الذي تنتمي إليه دما، ولكنها تفارقه، بل وتضاده، حركة وتنظيما وانتماء. ولهذا، فهي تحاول استجداء هذه الشرعية المفقودة من الداعم الإيراني، من الداعم الذي تحاول حماس - بأمواله الطاهرة! - شراء التأييد لها في الداخل الفلسطيني، على طريقة الشاعر الذي يقول: نأسو بأموالنا آثار أيدينا.
إذن، انعدام الشرعية لم يبدأ - وإن تأكد - بإقالة حكومة حماس. فدخولها في العملية الديمقراطية لم يكن شرعيا من الأساس؛ لأنها - كما ينصُّ ميثاقها وانتماؤها الحركي - لا تؤمن بشرعية النظام / السلطة التي تحاول الفوز بها، وليس لديها الاستعداد - الاستعداد الحقيقي - لممارسة السلطة بشروط السلطة؛ لأنها - كما تقول وتؤكد دائما - حركة مقاومة مسلحة. وهي تعد الكفاح المسلح هو القاعدة الشرعية لها. وهذه القاعدة الشرعية هي (فعل) خارج نطاق السلطة، أو يجب أن يبقى خارج نطاقها. فشرعية حماس - إن وجدت ولو بكثير من التجاوز - شرعية توجد - بالضرورة - خارج السلطة، لا داخلها.
على هذا، فحين تأتي حماس إلى السلطة، فإنه يجب عليها التنازل عن شرعيتها، شرعية وجودها، أو التنازل عن السلطة. وهذا ما يستحيل فعله واقعا. ولكن حماس وهي تتهالك على فتات السلطة تحاول فعل المستحيل. وحين ترتطم بجدار المستحيل الصلب؛ فإنها لا تتراجع، بل ولا حتى تمارس الخيار بين هذا وذاك، وإنما تلوم المستحيل لأنه مستحيل، وتعادي كل من يؤكد لها استحالة هذا المستحيل. ولا شك أن عقلا مأزوما كهذا، يستحيل عليه أن يتقدم خطوة واحدة في عالم السياسة؛ لأن السياسة تبدأ من نقطة الشرعيات المكتسبة، والمعترف بها من قبل المؤثرين - حقيقة - في السياق، وتمر عبر جسور الممكن والآني، ولا تنتهي إلا حيث تنتهي الإرادات الإنسانية الفاعلة. لقد واجهت حماس من بداية التسعينيات منذ القرن الماضي، وإلى اليوم، كثيرا من المآزق والأزمات، بل والتحديات من الداخل والخارج. لكن، ما يلفت النظر أن كل مأزق وكل أزمة، إنما كانت مرتبطة - على نحو لافت - بسؤال الشرعية. وفي كل مرة، كانت حماس تتوسل الشرعية - صراحة - إلى درجة الاستجداء، ولكنها - في الوقت نفسه - تهرب من شروطها الفكرية والعملية. كل المآزق الحمساوية، كانت ستكون قابلة للحل؛ فيما لو كان سؤال الشرعية محلولا، أو كانت شروطه قابلة للتفاوض.
لا يمكن فهم هذا السؤال الحاسم في سياق القضية، إلا بمراجعة الخطوط العريضة - دون الدخول في التفاصيل؛ مع أهميتها - لمسيرة علاقة حماس بالسلطة من جهة، وعلاقتها بالواقع الفلسطيني من جهة أخرى. فعندما بدأ تأسيس السلطة الوطنية بداية التسعينيات على مبدأ: خيار السلام، كتمهيد لتأسيس الدولة الفلسطينية الجامعة، كان رد حماس على هذا الخيار الفلسطيني، قيامها بتفجيرات إرهابية كبيرة عام 1994م في العمق الإسرائيلي؛ بغية إيقاف عملية السلام. كانت خطة حماس تمثل مشروعا ضد السياق المدني آنذاك. وهي خطة لا تكمن في مجرد إفساد السياق السلمي فحسب، وإنما تحاول - أيضا - الحصول على شرعية شعبية، من خلال العنف الدموي؛ كمقابل موضوعي للشرعية التي كان عرفات يحصل عليها من خلال عملية السلام. كانت حماس - آنذاك - تريد اعترافا - ولو هزيلا - من قبل الداخل الفلسطيني على الأقل. وكانت ترى في التفجيرات الإرهابية طريقا إلى عقل جماهيري مأزوم ومتخم بشعارات القوة الكاذبة، ووقائع النضال التاريخي!. وقد حقق لها هذا العبث المراهق نوعا من الشرعية، ولكنها كانت شرعية (شوارعية) على حساب مستقبل القضية الفلسطينية برمتها
 رد: حرب غزة.. الدين والسياسة والإنسان .....
رد: حرب غزة.. الدين والسياسة والإنسان .....
الجمعة فبراير 13, 2009 12:53 pm
يسلمووووووووووووووو على الموضووووووع ..ليس المهم ان يرضى الناس المهم ان يرضى قلمي .
 لحظة وفاءصقر ماسي
لحظة وفاءصقر ماسي
- عدد المشاركات : 1640
العمر : 42
أوسمة التميز :
تاريخ التسجيل : 10/01/2009
 رد: حرب غزة.. الدين والسياسة والإنسان .....
رد: حرب غزة.. الدين والسياسة والإنسان .....
الإثنين فبراير 16, 2009 2:18 pm
يسلمو على المرور
 الصقرالمقنعالصقرالمقنع
الصقرالمقنعالصقرالمقنع
- عدد المشاركات : 7031
العمر : 39
أوسمة التميز :
تاريخ التسجيل : 14/12/2008
 رد: حرب غزة.. الدين والسياسة والإنسان .....
رد: حرب غزة.. الدين والسياسة والإنسان .....
الثلاثاء أبريل 14, 2009 11:05 pm
تقبل مروري اخي العزيز
موضوعك جميل وتستحق
الشكر تحياتي
موضوعك جميل وتستحق
الشكر تحياتي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى